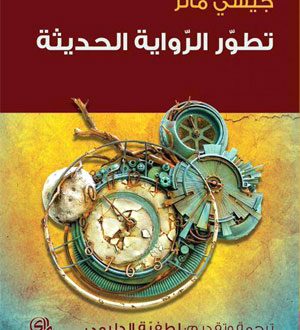من أحمد رجب
“إن موضوع هذا الكتاب يتأسس على مناقشة: لماذا وكيف لبست الرواية لبوس الحداثة؟ ويمكن عدّ هذا الكتاب بمثابة مقدِّمة إلى أشكال الرواية الحديثة والوظائف التي تنهض بها إلى جانب مساءلة الواقع، والتقنيات، والمعضلات، والتطوّر المرتبط بالرواية الحديثة”.
هكذا يحدد الأكاديمي الأميركي جيسي ماتز الهدف من كتابه ”الرواية الحديثة.. مقدمة قصيرة”، الذي ترجمته الكاتبة العراقية لطفية الدليمي، وأصدرته دار المدى بعنوان “تطور الرواية الحديثة”.
ويقرر المؤلف ابتداء من الجملة الأولى أن “الرواية ظلت حديثة على الدوام”، إذ انشغلت دائما بالحياة المعاصرة والأشياء المستحدثة فيها، والرواية هي الاشتغال المعرفيّ الوحيد الذي واصل الارتقاء، وذلك لأسباب كثيرة منها أن الرواية تمثّل نوعاً من الذاكرة الجمعيّة المميّزة للبشر، فهي بمثابة خزانة الحكايات الحافظة للمزايا المجتمعيّة والأنثروبولوجيّة لكلّ الشعوب، كما أنها تؤدّي وظيفة الأسطورة، فأصبحت بمثابة الفضاء الميتافيزيقيّ الذي يلجأ إليه الأفراد للإبحار في عوالم متخيّلة تشبه حلم يقظةٍ ممتدّاً، والرواية كذلك عمل تخييلي يبدأ بالمخيّلة ويتطوّر داخل فضائها، وهي كذلك لعبة ذهنيّة في المقام الأوّل، كما يمكن أن تكون الرّواية علاجاً لبعض الاضطرابات”.
وتذهب المترجمة أيضا إلى أن الرواية معلم حضاري وثقافي تنهض به العقول الراقية في مختلف الاشتغالات المعرفية، وهي جهد خلاق يرمي إلى فتح آفاق جديدة أمام الوعي البشري والخيال الإنساني، وأخيرا فالرواية أداة ناعمة من أدوات العولمة الثقافية.
أما عن سبب منحها الترجمة عنوانا غير الذي حمله الكتاب في نسخته الأصلية فتقول لطفية الدليمي: فضّلت عنْونة الكتاب “تطوّر الرواية الحديثة” لأنّه يتناول الرواية الحديثة في سياق تطوري إرتقائي منذ بواكير نشأتِها الأولى وحتى وقتنا الحاضر، ولم يكتفِ الكتاب بالإشتغال على الرواية الحديثة بل تناول في أحد فصوله مدخلاً موجزاً لِرواية ما بعد الحداثة، كما تناول في فصلٍ آخر مقدّمة موجزة لِلرواية مابعد الكولونياليّة، ولا يخفى ما لهذين النمطين الروائيّين الآن من أهميّة.
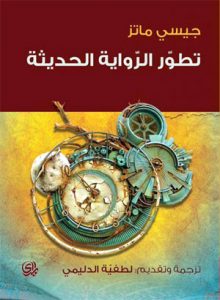
يتناول الكتاب في الفصول الأربعة الأولى نظرية الرواية الحديثة وفلسفتها، متسائلا “أين ومتى نشأت الرواية الحديثة؟” ويجيب بأن الرواية ترسخت حداثتها مع ظهور “الأستاذ” أو هنري جيمس الذي أثبت بإبداعه وتنظيره أن الرواية فن راسخ الأركان، وإن كانت البداية مع “مدام بوفاري” لغوستاف فلوبير (1856)، و”أزهار الشر” لشارل بودلير (1857)، لتكون الحداثة محاولة لتقويض الأشكال التقليدية للرواية التي فقدت الصلة مع الواقع. فالرواية الحديثة وفقا لماتز هي التي أحدثت قطيعة مع الماضي وجعلت من نفسها شكلا جديدا، فبعد أن شهد العالم تغيرا حاسماً لم يكن ممكنا للكتابة أن تمضي كما كانت من قبل، كما لم تعد للحكايات القديمة القدرة على أن تتضمن التجارب الجديدة التي أتاحتها الحداثة، فهشمت الرواية الحديثة الحبكة وفككت النهايات واقترب السرد الروائي من الأنماط الشائعة في التجارب الحياتية اليومية.
وفي الفصل الثاني يتساءل ماتز ما الواقع، ذلك أن “التشخيص الروائي استحال مسألة حدس فحسب بدلاً من كونه مسألة محسومة بصورة مسبقة”، وكان على الروائي أن “يتعامل مع الواقع لا باعتباره حقيقة مفروغاً منها بل باعتباره إشكالية دائمة”.
سيقود هذا إلى خلق نزعات أساسية ثلاث هي: “النزعة التشكيكية، النزعة النسبية، نزعة التهكم والسخرية والمفارقة”، و”لم يعد الواقع الآن شيئاً مؤكداً يقبع خارجاً عنّا وينبغي للروائي وصفه بل بات عملية اشتباك مع الوعي. وحتى تكون الرواية أقرب إلى الواقع كان عليها أن تعكس صورة غير متماسكة وغير متجانسة للواقع في متنها فقد “هشّم اللاتجانس الرواية الحديثة وحوّلها إلى شظايا” لنصل إلى “الرواية العديمة الحبكة، والمتشظية، وغير الكاشفة للحقائق ومفتقدة للصنعة الفنية لكنّها في واقع الحال يمكن أن تحتوي على شكل أكثر تشذيباً من الوقائع العارية، والمُساءلة الصبورة، والاستكشاف الحر، ويمكنها ملامسة سطح الحياة التي لم تتوار في الرواية الحديثة وما بعد الحديثة، لكنها باتت موضع تساؤل فيهما، مما انعكس على الشكل الروائي الذي كان سابقا في حاجة إلى النظام لكن الرواية الحديثة ستعتمد بدلاً عن ذلك اللا انتظام، والتمركز الطاغي حول الذات، والإرباك”.
في الفصل السادس يقوم جيسي ماتز بمُساءلة الحداثة، فمثلما انغمست الرواية الحديثة في مساءلة الواقع، فينبغي لها أيضاً مساءلة اللغة ذاتها، وبحسب قوله فقد “كثّف الشعور الجديد بـالإحساس المديني الإبداع الروائي، كما غيّر أسلوب المعيشة الحضرية بصورة كاملة من وظيفة الكاتب بعد أن جعلت حياته موضوعاً للحشود المكتظة، والانعزال المستحوذ، والعلاقات الأخطبوطية بعالم التجارة والثقافة المترامي الأطراف. حتى لو بدت الرواية الحديثة أحياناً مبتغاة لذاتها ومكتفية بفضائها الخاص ومهتمة بتوجيه بؤرتها نحو أساليبها وهياكلها الخاصة وحسب فإنها في نهاية المطاف صناعة تشكِّلها المعضلات والمسؤوليات الجمعية العامة”. وكما في روايات هنري ميللر “حل عدم التجانس النصي الداخلي محل الارتقاء الهادئ والمعقلن، وكسرت المشاعر المتفجرة حيادية وهدوء السرد الموضوعي، ومضت هذه التغيرات الروائية في لعب أدوارها التأثيرية بعد أن ترسخت سطوة النزعة الإيروتيكية كوسيلة في تحدّي الأعراف الاجتماعية التقليدية، ولجعل الرواية الحديثة أكثر انفتاحاً على الواقع”.
وعملت الوجودية والنزعة الإيروتيكية على تجذير التجريب الروائي، في أساسيات الحياة الحقيقية. وهذه التجديدات مما يؤدي بنا إلى “ما بعد الحداثة” لتؤصل الرواية “نوعاً جديداً متطرِّفاً من التجريب المقترن برؤية تشكيكية أكثر قسوة بكثير من تلك التي جاء بها المحدّثون الروائيون، وإذا كانت الرواية الحديثة قد حاولت، ملامسة الحقيقة فإن “النزعة التشكيكية ما بعد الحداثية أكدت على عدم إمكانية ملامسة الحقيقة بأي حال من الأحوال”. فصارت الرواية هي “التي تقود القارئ من خلال ما يشبه مدينة معارض تعج بالأوهام والخدع والأضاليل والمرايا المشوّهة وفخاخ الأبواب المغلقة التي تنفتح على حين غرّة تحت أقدام القارئ”. لتدور الرواية عندئذٍ حول وهمها الذاتي، أو زيفها الخاص والغريب أن الحبكة عادت إلى الرواية ثانية “ولكن كعنصر يعمل على تهشيم المواضعات الراسخة في نهاية المطاف”.
 مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع